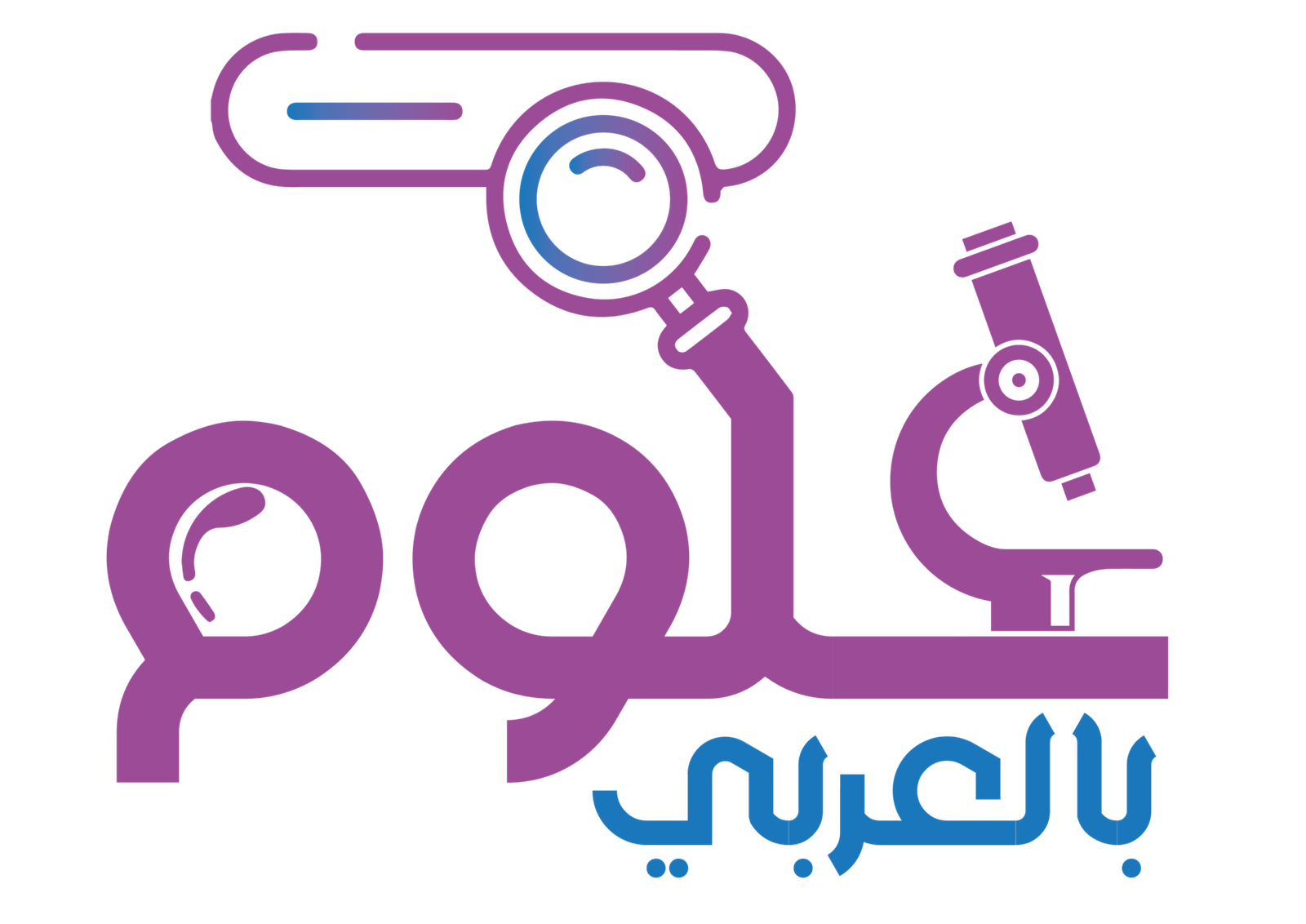مقدمة البحث:
تعتبر إدارة الجودة الشاملة من أهم المواضيع التي استحوذت على الاهتمام الكبير من قبل المديرين الممارسين والباحثين الاكاديميين كأحدي الأنماط الإدارية السائدة والمرغوبة في الفترة الحالية، يعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة فلسفة إدارية عصرية ترتكز علي عدد من المفاهيم الإدارية الحديثة الموجهة التي يستند إليها في المزج بين الوسائل الإدارية الأساسية والجهود الابتكارية وبين المهارات الفنية المتخصصة من أجل الارتقاء بمستوي الأداء والتحسين والتطوير المستمرين. (عبد الله وإسماعيل،2021)
ويمثل العنصر البشري أحد الركائز الأساسية لعمل منظمات الأعمال في ظل ما تواجهه اليوم من بيئة تنافسية شديدة (عباس وعنيد ، 2021) حيث يؤدي العنصر البشري دورًا رئيسيا في تحقيق أهداف المنظمة من خلال أداء المهام الموكولة إليه بكل كفاءة وفاعلية، لذلك فإنه من الضروري الإهتمام بالعنصر البشري وتنمية قدراته ومهاراته في بيئة العمل، ومساعدته على تحقيق أهدافه الشخصية في حياته الخاصة (منصور وعماد ، 2019).
يعد اهتمام المنظمة بالعنصر البشري سواء بالحياة الوظيفية أو الشخصية من أهم الأمور التي يجب على المنظمات التركيز عليها. لذا تُعبر هذه العملية عن مجموعة الإجراءات التي تتخذها المنظمة في سبيل تحسين جودة حياة العمل لموظفيها، نظراً لأن جودة حياة العمل تساهم بشكل كبير في تنفيذ إستراتيجية المنظمة بشكل كفؤ وتحقيق أهدافها بشكل كلي (الموايضة والجعافرة، 2021).
تعبر جودة حياة العمل عن كافة العمليات التي تقوم بها المنظمة بهدف تطوير قدرات موظفيها وتنمية مهاراتهم، وذلك من خلال الإهتمام بكل ما يؤثر على قدرتهم على أداء المهام الموكولة إليهم، سواء داخل بيئة العمل كالتدريب والتطوير أو في حياتهم الشخصية والاجتماعية والصحية. حيث إن الاهتمام بجودة حياة العمل للموظفين تسهم بشكل كبير في تهيئة بيئة عمل مريحة للموظفين، مما يؤدي إلى مساعدتهم على أداء مهامهم بكل كفاءة وفاعلية، وبالتالي تحقيق أهداف الموظفين الشخصية، وأهداف المنظمة ككل، وأهداف المتعاملين مع المنظمة.(الرميدى وأبوزيد،2021)
تسهم إدارة الجودة الشاملة في تحسين قدرات المنظمة التنافسية وزيادة فعاليتها ومرونتها وذلك من خلال إجراء التخطيط الملائم لجميع أنشطتها، بالإضافة إلى إشراك جميع العاملين في المنظمة لإتخاذ القرارات التي من شأنها أن تطور وتحسن العمل (2014 ,Oakland)، حيث إن إشراك جميع العاملين في المنظمة يُسهم بتوفير مناخ تعاوني تتظافر من خلاله جميع عناصر المنظمة من أجل تطوير وتحسين مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدمها المنظمة بإستمرار . جاء الاهتمام بجودة بيئة الأعمال والبحث عن آليات حديثة لغايات تطوير وتحسين معايير الجودة المطبق داخلها لإستقطاب عملائها وتمكين عامليها، وذلك لغايات تحسين جوده خدماتها المقدمة وزيادة الربحية والاستمرارية في العمل. (Al-Shawabke,2019 )
مشكلة البحث:
يعتبر الإهتمام في جودة حياة العمل عاملاً حاسماً في تحقيق ما يصبو إليه المورد البشري في المنظمات عموماً والبنك على وجه الخصوص. كما يساعد توفير بيئة عمل سليمة وناجحة في إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة مسلحة بالخبرة والمعرفة، تؤدي إلى تحسين مستوى رضاهم .(2021Srinivasaiah et al)
وفي السنوات الأخيرة، أدركت البنوك أهمية توفير مستوى حياة عمل يليق بالمورد البشري، إذ يطالب الموظفون بمكان عمل وأنظمة جيدة لتعزيز خبراتهم في العمل (Ooi et al,2013).
يرى (2019Ackah,)أن إدارة الجودة الشاملة لا تركز على جودة المنتجات فقط، بل تركز على جودة الموارد البشرية ايضاً. في الواقع يعتمد بشكل كبير نجاح معظم ممارسات إدارة الجودة الشاملة على إحداث التغييرات في مواقف وأنشطة الموارد البشرية، إذ تمكنت البنوك التي طبقت ممارسات إدارة الجودة الشاملة من تحسين مستوى رضا المورد البشري وتقليل معدل الدوران والسلامة والصحة. كما أكد (Srinivasaiah et al., 2021)على وجود فجوة كبيرة في الأدبيات التي ربطت بين إدارة الجودة الشاملة وإدارة الموارد البشرية. لذا جاءت هذه الدراسة لتحليل العوامل التي تؤثر في جودة حياة العمل، ومن بين هذه العوامل ممارسات إدارة الجودة الشاملة.
التساؤلات البحثية:
- ما مستوى تطبيق ممارسات إدارة الجودة الشاملة بأبعادها (التزام الإدارة العليا، التركيز على متلقي الخدمة اندماج ومشاركة العاملين، إدارة العلاقات، تطوير العمليات، التحسين المستمر) على العاملين في مصرف الراجحي ؟
- ما مستوى جودة حياة العمل ممثلة بـ (التوازن بين الشخصية والعمل، تحقيق الذات، ظروف العمل المادية وغير المادية، علاقات العمل) على العاملين في مصرف الراجحي ؟
- هل هناك أثراً لممارسات إدارة الجودة الشاملةبأبعادها مجمعه في جودة حياة العمل ممثلة بـ (التوازن بين الشخصية والعمل، تحقيق الذات ظروف العمل المادية وغير المادية ، علاقات العمل) على العاملين في مصرف الراجحي ؟
هدف البحث
يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في معرفة أثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة بأبعادها في جودة حياة العمل بأبعادها على العاملين في مصرف الراجحي، و لتحقيق هذا الهدف، تم تحديد الأهداف الفرعية التالية:
- التعرف على أثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة بأبعادها مجمعة (التزام الإدارة العليا، التركيز على متلقي الخدمة اندماج ومشاركة العاملين، إدارة العلاقات، تطوير العمليات، التحسين المستمر) في التوازن بين الشخصية والعمل على العاملين في مصرف الراجحي
- التعرف على أثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة بأبعادها (التزام الإدارة العليا، التركيز على متلقي الخدمة اندماج ومشاركة العاملين، إدارة العلاقات، تطوير العمليات، التحسين المستمر) في تحقيق الذات على العاملين في مصرف الراجحي
- التعرف على أثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة بأبعادها (التزام الإدارة العليا، التركيز على متلقي الخدمة اندماج ومشاركة العاملين، إدارة العلاقات، تطوير العمليات، التحسين المستمر) على ظروف العمل المادية وغير المادية على العاملين في مصرف الراجحي
- التعرف على أثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة بأبعادها (التزام الإدارة العليا، التركيز على متلقي الخدمة اندماج ومشاركة العاملين، إدارة العلاقات، تطوير العمليات، التحسين المستمر) على علاقات العمل على العاملين في مصرف الراجحي
- تقديم توصيات واقتراحات لتحسين الجودة الشاملة وبالتالي تحقيق جودة حياة العمل على العاملين في مصرف الراجحي.
منهجية البحث:
سيتم اتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي كأسلوب مناسب للوصف، الذي يتطابق مع الفصول النظرية أما في الفصل التطبيقي التحليلي والمنهج الاستنباطي من أجل تحليل وتقييم البيانات المتحصل عليها في الاستبانة للمصرف محل الدراسة باعتباره ملائما لتقرير الحقائق وفهم مكونات الموضوع، مع إخضاعه للدراسة الدقيقة وتحليل أبعاده، والتي سنتطرق إليها في الفصل التطبيقي في دراسة الحالة.
يعتمد اختيار المنهج الملائم لطبيعة البحث على طبيعة المشكلة والهدف من دراستها، ومن أجل الإحاطة بمختلف جوانب الدراسة سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، فالأسلوب الوصفي مناسب للوصف الذي يتطابق مع الفصول النظرية، أما في الفصل التطبيقي التحليلي والمنهج الاستنباطي من أجل تحليل وتقييم البيانات المتحصل عليها في الاستبانة للمؤسسة محل الدراسة.
الفصل الثاني : الاطار النظري
المبحث الأول: إدارة الجودة الشاملة
يعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة من المفاهيم الإدارية الهامة إذ استحوذ هذا المفهوم على اهتمام الباحثين، والأكاديميين ومنظمات الأعمال على حد سواء، فأخذت تسعى منظمات الأعمال إلى تحقيق الجودة في كافة إجراءاتها وأنظمتها وأدائها ومنتجاتها وخدماتها وجعلت الجودة الهدف الأول لها في ظل عالم يسوده المنافسة. إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يساهم في معالجة المشاكل والأسباب التي تؤدي إلى تدني مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدمها المنظمات، وتسعى إدارة الجودة الشاملة إلى تحقيق أهداف المنظمة، وتحقيق رضا العملاء والعمل على إسعاد العميل الخارجي والداخلي، والتنبؤ بحاجات وتوقعات العملاء والعمل على تلبيتها. Mohamed& Adam, 2019).).
1.1.2 مفهوم إدارة الجودة الشاملة:
لقد ظهر مفهوم الجودة في اليابان خلال خمسينيات القرن الماضي، فاهتم العديد من الباحثين من رواد الجودة، مثل: جوران ،دمينج، كروسبي، اشيكاوا) بدراسة الجودة، باعتبارها القاعدة، أو الأساس الذي انطلقت منه إدارة الجودة الشاملة (عقيلي ،2009)
وقد عرف (Joseph Juran) الجودة بأنها مدى ملاءمة المنتج للغرض، أو الاستعمال، وعرف (Feignbaum) الجودة بأنها نتاج تفاعل خصائص نشاطات المنظمة، مثل: التسويق، والصيانة، والهندسة، مما يمكن المنظمة من تلبية حاجات العملاء، ورغباتهم. (جودة ،2018)
وعرف (Edward Deming) الجودة بأنها توجه لإشباع حاجات العميل في الحاضر، والمستقبل”. (علي، 2016). وعرفت الجودة أيضا بأنها إنتاج المنظمة لمنتج، أو خدمة بمستوى عال من التميز، إذ تكون المنظمة قادرة على تلبية احتياجات العملاء، ورغباتهم، بالشكل الذي يتفق مع توقعاتهم، وتحقيق السعادة، والرضا لديهم، ويكون ذلك من خلال وضع مقاييس موضوعة سابقا، لإنتاج المنتج، أو الخدمة، وإيجاد صفة التميز فيها.( عقيلى،2009 )
والجودة أيضا عبارة عن مجموعة الصفات، والخصائص الموجودة في المنتج التي تلبي الحاجات والرغبات الضمنية والصريحة الحالية والمستقبلية للعميل. ( على ، 2016 )
وقد أصبحت الجودة واحدة من أهم محركات المنافسة في العصر الحالي، إذ باتت إدارة الجودة الشاملة المحدد الحاسم في نجاح المنظمات الصناعية والخدمية، واستمرارها في بيئة تنافسية، ويمكن التعبير عن إدارة الجودة الشاملة كفلسفة إدارية، إذ هي قاعدة أساسية، لتحسين الجودة، والإنتاجية في المنظمات حسب ما أكدته دراسة (2021,Al-Qudah).
ونتيجة لذلك وبناء على ما سبق، فقد أصبحت إدارة الجودة الشاملة نهجا إداريا مطلوبا تطبيقه في منظمات الأعمال، من أجل تحسين مستوى جودة السلع والخدمات المقدمة للعملاء، أو تحسين جودة العمليات داخل المنظمة، لذا تجدر الإشارة إلى أن جودة السلع والخدمات ما هي إلا نتاج جودة العمليات الداخلية للمنظمة، فالتركيز لا يكون فقط على توفير سلع وخدمات تتميز بالجودة، بل يجب أن تخضع العمليات والأنشطة الداخلية في المنظمة لمعايير الجودة (المالكي، 2018).
وهناك العديد من المفاهيم التي أوردتها الأدبيات، لتحديد مفهوم إدارة الجودة الشاملة، غير أن إدارة الجودة الشاملة – كغيرها من المفاهيم – لم يجمع الباحثون، ولم يضعوا له تعريفا قاطعا ، فاختلفت وجهات نظر الباحثين في وضع تعريف عام، بالرغم من وجود تقارب كبير في محتوى هذه المفاهيم، إذ أن معظمها تمحور حول أنها رؤية إستراتيجية شمولية للجودة، وهي نهج يعتمد على سياسة المنظمة، وتعتبر الجودة مسؤولية جميع موظفي المنظمة، بما في ذلك فريق الإدارة العليا، إضافة إلى أنها منهجية متكاملة، لمطابقة المعايير، ومتطلبات السوق، لتحقيق جودة أفضل، أي إنها فلسفة او منهج لعملية التحسين المستمر. (2017,.Najm et al).
لذلك لا بد من التطرق إلى تحديد مفهوم كل من الإدارة الجودة والشاملة، كل على حدى، للوصول إلى مفهوم شامل ومتكامل لإدارة الجودة الشاملة، فالإدارة هي تخطيط وتنظيم، وتوجيه، ومراقبة جميع النشاطات التي تتعلق بتطبيق الجودة ودعم نشاطاتها، وتوفير الموارد الضرورية (جودة، 2018 )
والجودة هي اللبنة الأساسية التي انطلقت منها إدارة الجودة الشاملة، وتعني تقديم أفضل ما يمكن للعملاء، من أجل الوفاء بمتطلبات العملاء، ورغباتهم، وتجاوز توقعاتهم، إذ تضمن جودة المنتج، والخدمة، وجودة المسؤولية الاجتماعية، وجودة السعر، والتسليم في الموعد المحدد (جودة،2018)،(علي،2016) (EL-Hawi & Alzyadat,2019) أما مفهوم الشاملة فيتمثل في سعي المنظمة، إلى تحقيق الجودة في إستراتيجياتها، وأهدافها، ونشاطاتها، وأسلوب العمل، والهيكل التنظيمي، والنظم والإجراءات والعمل على إحداث تغيير جذري، وشامل لكل مكونات المنظمة، وتقع مسؤولية تحقيق الجودة الشاملة على جميع العاملين في المنظمة (جودة 2018)؛ قد اعتبرا أن أن الجودة الشاملة هي تكامل جميع الوظائف، والعمليات داخل المنظمة، من أجل تحقيق التحسين المستمر ، وضمان جودة المنتجات والخدمات. ولا شك أن إدارة الجودة الشاملة أمر أساسي للتنافس في الأسواق التنافسية العالمية، بحيث تركز على إرضاء العملاء، وعلى جودة الموردين في سلسلة التوريد.
وإدارة الجودة الشاملة هي أسلوب أو نهج الإدارة الرائدة في عالم الأعمال، وتلجأ إليها المنظمات لتحسين إنتاجيتها وجودة خدماتها ومنتجاتها، من أجل تحسين مقاييس أداء العمل مثل: زيادة الأرباح، وزيادة حصتها في السوق، وخفض التكاليف. ويعتبر معظم منتجي السلع أن الجودة هي أحد مظاهر إستراتيجيات التصنيع، واستراتيجيات الخدمة، واستراتيجيات المشتري. (2016,Kim).
وقد تناول العديد من الباحثين أمثال (جوران (كروسبي وغيرهم من منظري الجودة أهمية تطبيق نظام الجودة، وثقافتها، التي بدورها توفر المبادئ الأساسية لإدارة الجودة الشاملة، كفلسفة إدارية، تعمل على تنظيم الأنشطة، وتخطيطها، وتحسينها، تلك الأنشطة التي يتعين على الإدارة، والموظفين القيام بها، والمشاركة في تحسين العمليات والمخرجات، لذا لا يوجد تعريف عام لإدارة الجودة الشاملة يمكن أن يصلح، أو يمكن تنفيذه في جميع المنظمات، داخل جميع القطاعات.
وتختلف تعريفات إدارة الجودة الشاملة في كل منطقة، ودولة، وهذا الاختلاف يتأتى من ثقافة المجتمعات المختلفة، والثقافة التنظيمية، لكل منظمة أعمال، وكيفية إدراك المنظمة لمفهوم الجودة، وإدارة الجودة الشاملة هي ثقافة تتبناها المنظمة، وتقوم بنشرها، بين الموظفين جميعهم في المنظمة، لتحقيق رضا العملاء. (El-Tohamy & Al Raoush, 2015) ويتم تطبيق إدارة الجودة الشاملة على نطاق واسع، في منظمات الأعمال، في جميع أنحاء العالم، وقد توصلت العديد من هذه المنظمات إلى استنتاج مفاده أن تنفيذ إدارة الجودة الشاملة يُمكن أن يؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للمنظمة، وتوفيرمزايا إستراتيجية في السوق(Boikanyo& Heyns ,2019 ).
في حين أشار (2019El Hawi & Alzyadat, ( إلى إدارة الجودة الشاملة بأنها عملية تشمل جميع العاملين في المنظمة من جميع المستويات الإدارية، وتقوم على تشجيع العاملين على تحليل المشكلات، ووضع استراتيجيات، للتطوير والتحسين،ووضع حلول لتلك المشكلات، ومراقبة العمليات الداخلية المستمرة، وتقييمها، وإدارتها، وتحسينها، ومتابعتها وتطويرها داخل المنظمة.
وقد أوضحت (2017, Ana (إدارة الجودة الشاملة على أنها إستراتيجية إدارية تهدف إلى تضمين الجودة، في جميع عمليات المنظمة على أن يشارك الجميع في المنظمة في عملية التحسين المستمر للأنشطة، في جميع إدارات المنظمة، بهدف تحقيق رضا العملاء، ويمكن تطبيق إدارة الجودة الشاملة بنجاح في عمليات الإنتاج والخدمات، والتدريب، وغيرها.
يرى (2017 ,.Najm et al (أن إدارة الجودة الشاملة هي رؤية إستراتيجية شمولية للجودة، وهي نهج قائم على سياسة المنظمة، وتعتبر الجودة مسؤولية جميع موظفي المنظمة، بمن في ذلك فريق الإدارة العليا، وإنها منهجية متكاملة، لمطابقة المعايير، ومتطلبات السوق، لتحقيق جودة أفضل، أو فلسفة التحسين المستمر. فإدارة الجودة الشاملة عملية تقودها الإدارة، للحصول على مشاركة جميع الموظفين، في التحسين المستمر ولتلبية احتياجات العملاء الداخليين، والخارجيين وتحقيق رضاهم. (Boikanyo& Heyns, 2019)
اعتبر العبداللات (2015) أن إدارة الجودة الشاملة من المفاهيم الإدارية، التي تتبانها المنظمات من أجل تحسين منتجاتها وخدماتها، وتطويرها، لمواجهة المنافسة مما يتطلب اتباع أساليب إدارية فعّالة، لاستثمار عناصر الإنتاج لتقديم منتجات، أو خدمات متميزة، والأساليب الإدارية تستند إلى مهارات بشرية عالية، إذ تمثل الموارد البشرية، وموارد الإنتاج، دورا فاعلا في إكساب المنظمات ميزة تنافسية، من خلال استثمار تلك الموارد بشكل أمثل، بهدف رفع الإنتاجية، وتحسين الجودة.
وبين )سويسي وأبو قفة ،2015) أن إدارة الجودة الشاملة فلسفة صممت لتغيير الثقافة التنظيمية، بما يجعل المنظمة سريعة ومرنة للاستجابة لطلبات العملاء والتركيز عليهم، إذ يسود المنظمة مناخ وبيئة يشجعان على مشاركة الموظفين في التخطيط والتنفيذ، والتحسين المستمر ، لمواجهة احتياجات العملاء. وعند تطبيق إدارة الجودة الشاملة، ومبادئها، سيظهر ذلك جليا على تحسين الأداء التشغيلي للمنظمة، فإدارة الجودة الشاملة تهدف إلى الحصول على مزايا تنافسية، فأي انخفاض في رضا العملاء بسبب تدني جودة المنتج أو الخدمة، قد يكون سببًا في فشل المنظمة، ونتيجة لازدياد وعي العملاء بمعايير جودة المنتجات والخدمات مما يؤدى إلى ارتفاع توقعاتهم، فتبقى تلبية احتياجات العملاء أمرا تنافسيا (AL-Qudah,2021)
ويعتبر تطبيق معايير الجودة الشاملة من الأساليب الإدارية الحديثة، التي تلجأ إليها المنظمات من أجل البقاء، والاستمرار، وزيادة الميزة التنافسية على المستوى العالمي، والمحلي )إبراهيم، وفضل الله، 2019)
وتعد إدارة الجودة الشاملة نهجا إداريا يركز على الجودة، ويستند على مشاركة العاملين داخل المنظمة، بهدف تحقيق النجاح على المدى الطويل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال رضا العملاء .
تركز إدارة الجودة الشاملة على تحقيق الجودة سواء في المنتجات أو الخدمات ، الاجراءات، السياسات الأنظمة المتبعة في المنظمة، وتقوم على مشاركة جميع العاملين في المنظمة، بهدف تحقيق النجاح على المدى الطويل، من خلال إرضاء العملاء وتحقيق المنافع لجميع أعضاء المنظمة، والمجتمع. (El-Tohamy & Al Raoush,2015)
ويتطلب تطبيق إدارة الجودة الشاملة، توفير الظروف الملائمة من تعاون بين الإدارات والأقسام المختلفة، ذات الصلة بعمليات الشراء والتخزين، والإنتاج والتسويق، والتمويل، والنقل، وإدارة الموارد البشرية، أي أن الجودة مسؤولية الجميع (العبداللات،2015) أدت المنافسة العالمية، وتزايد طلب العملاء للحصول على جودة أفضل، إلى جعل المنظمات أكثر وعيا، بضرورة تقديم منتج و / أو خدمات عالية الجودة للتنافس في السوق بنجاح، من أجل مواجهة المنافسة العالمية. (2021,Al Qudah).
وبناء على ما سبق، فإن هذه الدراسة ترى أن إدارة الجودة الشاملة هي نهج أو فلسفة إدارية تعزز ثقافة الجودة، وتتبناها الشركات الأردنية لصناعة الأدوية البشرية، لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وأهمها رضا العملاء وتحقيق السعادة لهم، وتعزيز قدرتها التنافسية بين الشركات المنافسة في القطاع الدوائي من خلال تقديم منتجات وخدمات مميزة، وذات جودة عالية بمشاركة جميع العاملين في المنظمة على جميع المستويات الإدارية باعتبار الجودة مسؤولية الجميع.
2.1.2 أهمية إدارة الجودة الشاملة
وقد حظي مفهوم إدارة الجودة الشاملة بمستوى عال من الاهتمام، على مستوى العالم في الآونة الأخيرة، لأنه يؤثر على أداء المنظمة، وعلى قدرتها في تحقيق الميزة التنافسية. وأن إدارة الجودة الشاملة هي ظاهرة إدارية ظهرت لتكون أداة تنافسية على المستوى العالمي، أي إنها بمثابة سلاح يمكن استخدامه بشكل مثالي لتلبية توقعات العملاء، وتجاوزها، فالعالم أصبح قرية عالمية، مما سهل التجارة بشكل كبير، وشجع المنظمات على بناء الجودة في منتجاتها، وخدماتها، والتركيز على العميل، لأنه المفتاح الحيوي لنجاح المنظمات، وأصبحت المنظمة تنظر وتقيم أداءها من خلاله، وقياس أدائها، وفقا لتوقعات العملاء، وليس توقعات المنظمة.(Jonah, et al.,2018)
كما أدركت المنظمات الأهمية الإستراتيجية لإدارة الجودة الشاملة، فتراها كأداة إدارية، لتحقيق القدرة التنافسية في السوق. (2018 ,.Jonah, et al)
فهي تعمل على إحداث تغيرات مستمرة في أسلوب عمل المنظمة، وفلسفتها وأهدافها، لإجراء تحسينات شاملة، في جميع مراحل العمل بالشكل الذي يتوافق مع المواصفات المحددة سابقا، لتحقيق رضا العميل. (المحاسنة 2016).
في ظل التطورات والتغيرات التي تشهدها منظمات الأعمال، ونظرا للأهمية المرتبطة بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، فقد اتسع نطاق استخدام المنظمات المعاصرة لهذا المفهوم، مما يجعل المنظمات على اختلافها – تأخذ على عاتقها تبني هذا المفهوم. وينشأ الاهتمام المتزايد بهذا المفهوم، من تأثيره المؤكد على تحقيق رضا العملاء، وزيادة أرباح المنظمة، وزيادة الإيرادات التي تتنى من ولاء العملاء. فمعظم مديري المنظمات المنافسة يعتبرون أن الجودة الشاملة تسهم بشكل أساسي في نجاح الأعمال (2017,Androniceanu).
وترتبط إدارة الجودة الشاملة بجميع وظائف المنظمة، فهي ليست جزءا من العمل فحسب، بل هي إستراتيجية أساسية للعمل الناجح، فإذا كانت الأعمال تعتمد إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة فقط، فيمكنها البقاء في عالم المنافسة.
ويمكن تحديد أهمية إدارة الجودة الشاملة فيما يأتي(دودين، 2019).:
- تقليص شكاوى العملاء، من خلال فهم حاجاتهم، ورغباتهم، وإدراكها، والعمل على تحقيق رغباتهم، وتجاوز هذه الرغبات.
- زيادة كفاءة المنظمة وفعاليتها، من خلال تحقيق رضا العملاء، بتقديم منتجات وخدمات تتوافق مع رغباتهم، وحاجاتهم.
- رفع مستوى الرضا الوظيفي للعاملين، وتنمية روح العمل الجماعي.
- تحسين عملية اتخاذ القرارات.
- تخفيض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية.
- زيادة ربح المنظمة، وحصتها السوقية، وقدرتها على المنافسة، وزيادة إيرادات المنظمة
ويتضح مما سبق أن أهمية إدارة الجودة الشاملة لمنظمات الأعمال المعاصرة، قد دفعت الكثير منها إلى تبني هذا التوجه، إذ يرسم مستقبل المنظمة، ويسعى إلى تحقيق مزاياها التنافسية.
واستنادا إلى ما تقدم يمكن لهذه الدراسة إضافة بعض النقاط التي تظهر أهمية إدارة الجودة الشاملة للمنظمات، التي يمكن عرضها كما يلي: –
- تحقيق النمو، والبقاء، والاستمرارية للمنظمة.
- القدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، والاستجابة لتلك المتغيرات.
- رسم صورة جيدة عن المنظمة في أذهان العملاء، وأذهان أصحاب المصلحة، والمساهمين.
- التشجيع على تطبيق عمليات متطورة، ومبتكرة لتحسين جودة المنتجات.
- زيادة الأمان الوظيفي، ورفع معنويات الموظفين، من خلال إشراكهم في بعض القرارات.
- التشجيع على توليد الأفكار الإبداعية، التي من شأنها تطوير المنتجات وتحسينها.
3.1.2 مبادئ إدارة الجودة الشاملة:
تستند إدارة الجودة الشاملة على عدة مبادئ وأبعاد، فقد اختلف الكتاب والباحثون حول تحديد أبعاد إدارة الجودة الشاملة، فتناولتها العديد من الدراسات النظرية، والعملية، فسماها بعضهم ممارسات إدارة الجودة الشاملة، ووصفها آخرون بمبادئ إدارة الجودة الشاملة، ووصفها فريق ثالث بأبعاد إدارة الجودة الشاملة، ومنشأ هذا الاختلاف هو خبرات الباحثين الأكاديمية والعملية، وأن معظم الباحثين والكتاب في مجال إدارة الجودة الشاملة بنوا دراساتهم على ما أشارت إليه المبادئ التي نادى بها جوران وديمنغ وهناك من استند على ثمانية مبادئ الإدارة الجودة الشاملة التي وضعت على أساس المعيار الدولي (ISO 9004:2009)
وقد تم دراسة إدارة الجودة الشاملة من خلال عدة أبعاد منها التركيز على العملاء، العلاقة التكاملية مع الموردين، ودعم الإدارة العليا، وتشجيع العاملين للتعاون مع بعضهم البعض، والتحسين المستمر للمدخلات، والعمليات الداخلية والمخرجات، وإدارة العمليات – إدارة الموارد والأنشطة بكفاءة وفعالية، أما البعد الأخير فكان دعم الموارد البشرية، من خلال تحفيز العاملين، وتشجيعهم ومكافأتهم، وتقديم الدعم الكافي لهم (2019,Al-Ali Abu Rumman) ومنهم من أضاف بعد ثقافة الجودة، والتدريب وتطوير العاملين، والاتصالات (2017,Aletaiby et al). وقد أضاف بعد التخطيط الإستراتيجي للجودة، وبعد تصميم المنتج والخدمة، وبعد المعلومات والتحليل. أما (2019) ,.Al-Sarayreh et al فقد أضاف إلى أبعاد إدارة الجودة الشاملة بعد توقعات الزبائن وحاجاتهم، وبعد توقعات الموظفين وحاجاتهم، وإجراءات العمل، في حين أضاف (2016 ,.(Kumar et al بعد الإدارة المستندة على الحقائق، وبعد العمل الجماعي، وبعد النظام المتكامل.
- أولاً: التزام القيادة:
يعتبر التزام القيادة نقطة الانطلاق التي تنطلق منها أنشطة الجودة، إذ يمثل التزام الإدارة العليا القوة الدافعة الرئيسة، وراء إدارة الجودة الشاملة، ولا يمكن تحويل أي منظمة إلى إدارة الجودة الشاملة، إذا لم تقم الإدارة العليا بدعم ممارسات إدارة الجودة الشاملة في المنظمة، فإن المهمة الأساسية للإدارة العليا هي ضمان هذا التحول والتأكد منه، والالتزام تجاه دعم أنشطة إدارة الجودة الشاملة. (Aletaiby et al., 2017)
يلعب القادة دوراً حاسماً في نجاح إدارة الجودة الشاملة، لأنهم مسؤولون عن وضع الأهداف، والاستثمار في العاملين، وتدريبهم، وتطوير علاقات تعاونية مع العملاء، وتطبيق الممارسات المرتبطة بتحقيق التحسين المستمر، وبدوره يؤثر التحسين المستمر على نتائج الجودة ويتمثل التزام الإدارة العليا بالاقتناع، والاستعداد لتبني تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة داخل المنظمة .
ومن وجهة نظر ( Ganapavarapu & Prathigadapa ,2015) أن على الإدارة العليا ترسيخ وحدة الهدف، والعمل على إيجاد بيئة داخلية، يمكن من خلالها أن يشارك العاملون في تحقيق أهداف المنظمة. وقد كان أحد المبادئ الأربعة عشر التي نادى بها ديمنج وهو الأب الروحي الإدارة الجودة هو التزام الإدارة العليا، ودعمها لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، وهذا يتطلب منها معرفة المفاهيم الأساسية للجودة، وأن تهتم الإدارة العليا بإستراتيجية إدارة الجودة الشاملة، وتقوم بخطوات إيجابية لتحقيقها. (دودين ، 2019).
ووضح (2018) .Singh et al أن القيادة في المنظمة هي عامل مهم لإدارة الجودة الشاملة. القيادة العليا للإدارة تشارك في عملية الاتصال، والتخطيط للأهداف التنظيمية، وتوفر القيادة الإدارية وسائل وموارد مهمة، لتحسين الجودة، والحفاظ عليها. ومن أهم مسؤوليات الإدارة العليا قيادة عملية التنفيذ المبادئ إدارة الجودة الشاملة، وتطبيقها، والتواصل المستمر مع الإدارات، والعاملين في المنظمة.
وقد كان الافتقار إلى الدعم الإداري، وعدم مشاركة الموظفين، والقيادة الضعيفة، ونقص التدريب، والثقافة التنظيمية غير الملائمة، وعدم الاعتراف بمكافأة النجاح، والهيكل التنظيمي الهرمي، والسلطوي هو أكثر العوائق، التي تعيق تنفيذ إدارة الجودة الشاملة بنجاح.
كما أشارت (2017) Al-Damen إلى أن التزام الإدارة العليا يتمركز حول درجة قبول مسؤولية الجودة، من الإدارة العليا، والمشاركة في جهود تحسين الجودة ومراقبة هذا التطبيق، بما في ذلك، تحديد ثقافة الجودة، والالتزام بتحسين الجودة وتوجيه المنظمة، والتأثير عليها في تحديد اتجاه إستراتيجية الجودة، والحفاظ على القيادة الفعالة بالإضافة إلى وضع السياسة والخطة الإستراتيجية لتطبيق الجودة. وفي ظل وجود التزام الإدارة العليا، فإن هذا من شأنه أن يساعد المنظمات، على المدى الطويل على تحسين أدائها، والاستجابة لاحتياجات العملاء، وتوقعاتهم، الداخليين، والخارجيين بفعالية، وكفاءة. (2018,Alghamdi ) .
وكذلك أكد )سويسي وأبو قفه ،2015) على أهمية اقتناع الإدارة العليا في مشاركة العاملين في عملية اتخاذ القرار، من أجل تقديم منتجات وخدمات جديدة. كما أن من أهم مسؤوليات الإدارة العليا اتجاه تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة أن تقوم بدعم ثقافة الجودة، بدءًا من رؤية الجودة، وقيمها، إلى مفهوم إدارة الجودة، وإدماجها الكامل في أسلوب إدارة المنظمة.
ويعد التزام الإدارة العليا مطلباً أساسياً، لتنفيذ إدارة الجودة الشاملة، التي تحتاج إلى بذل أقصى الجهود من كل موظف في المنظمة، من أجل الحفاظ على رضاء العملاء، فعدم وجود قيادة واضحة ومتسقة للجودة، يؤدي إلى فشلها، أي يجب على الإدارة تسهيل البيئة المناسبة للعاملين، بهدف تحسين الأداء، والإنتاجية، إذ يرى (جوران1974) أن معظم القضايا المتعلقة بالجودة ترتبط بالإدارة، مما يشير إلى أن إدارة الجودة الناجحة تعتمد على مدى التزام الإدارة، وكذلك يعتبر مسؤولية الجودة تعزى إلى الإدارة العليا، بينما بينت بعض الدراسات أن مــــن حالات فشل إدارة الجودة الشاملة ارتباطها بعدم وجود التزام من الإدارة العليا. (Alotaibi et al., 2013)
ويتطلب التزام الإدارة العليا وقيادتها تغييرا فعالا في الثقافة التنظيمية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال المشاركة الفعالة للإدارة العليا، في إستراتيجية المنظمة للتحسين المستمر، والاتصال المفتوح، والتعاون بين جميع أعضاء المنظمة (2018 ,Keinan& Karugu). ومن الجدير بالذكر أن الدراسة كانت قد بينت هذه الأبعاد وذلك لإجماع الباحثين عليها وعلاقتها مع بيئة الدراسة وهي: وبناء على ما سبق تم التوصل إلى أن التزام الإدارة العليا تتمحور حول وضع رؤية واضحة تدعم ثقافة الجودة وتعمل على نشرها، وضرورة قيام الإدارة العليا بتوفير الدعم المادي والمعنوي وإيجاد بيئة داخلية مهيأة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، مما ينعكس على تحسين أداء المنظمة، وإكسابها قدرة تنافسية وتحقيق الهدف الأساسي للمنظمة وهو رضا العملاء.
- ثانياً: مشاركة العاملين:
مشاركة العاملين تعتبر أحد متطلبات نجاح إدارة الجودة الشاملة فالعاملين هم مصدر للأفكار والإبداع وخاصة التي تتعلق بالجودة وتحسين وتطوير المنتجات والخدمات، فإن تشارك وتفاعل العاملين مع بعضهم البعض من خلال التفاعلات الرسمية وغير الرسمية، وتشكيل فرق لحل المشاكل التي تواجه المنظمة وتنسيق العمل بين أعضائها والتعاون فيما بينهم حيث تقوم هذه الفرق بتقديم المقترحات المناسبة، وتبادل الأفكار والآراء وبذلك تكون مهاراتهم متممة لبعضها البعض سيكون له الأثر في تحقيق أهداف المنظمة العزاوي (2010) مما يشير إلى أن العاملين لديهم روابط قوية مع منظمتهم، ويشاركون في عملية صنع القرار، ويشعرون بأنهم أكثر التزاما بعملهم، ويشعرون بأن وظائفهم مهمة، وتوفر مشاركة العاملين مزايا تزيد من معنويات العاملين، والتزامهم بالمنظمة وتعزز الإبداع والابتكار لديهم، وبالتالي تعتبر بمثابة مصدر للميزة التنافسية .
علاوة على ذلك، تعمل مشاركة العاملين على تحسين الأداء التنظيمي للمنظمة والعاملين (2016,Kim). ويكون إشراك العاملين من خلال الأنشطة لتحسين الجودة مثل: العمل الجماعي، اقتراحات العاملين، والتزام الموظفين. (2017,Al-Damen)
وتعد مشاركة العاملين في عملية صنع القرار من الأساسيات المهمة في إدارة الجودة الشاملة، فالعاملون يعتبرون عملاء داخليين، يجب إرضاؤهم، فعلى الإدارة العليا إتاحة فرص المشاركة للعاملين، وتحفيزهم بشكل دائم ومستمر، وتشجيعهم على تقديم مقترحاتهم، وأراءهم فيما يتعلق بالتحسين المستمر ، وأن تقدير العاملين من قبل الإدارة يؤدي إلى تشجيعهم وزرع الثقة لديهم، ودعم أدائهم، وأن العمل على إعداد نظام للحوافز وبناء قنوات اتصال تتيح تدفق المعلومات مما يشجعهم على المشاركة في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة. (المالكي، 2018).
لتحميله كاملا اضغط أثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة في جودة حياة العمل دراسة تطبيقية على العاملين في مصرف الراجحيأثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة في جودة حياة العمل دراسة تطبيقية على العاملين في مصرف الراجحي
يساعد التعليم والتدريب على تطوير قدرات العاملين بشكل مستمر. وعملية التعليم والتدريب المستمر، توفر أساسًا جيدًا للتغيير الثقافي المطلوب والمرغوب، لتطبيق إدارة الجودة الشاملة( 2015,Mosadeghrad). ويتوجب على المنظمة إعداد برامج مشاركة العاملين، وخاصة مشاركتهم في قرارات الجودة. (Bouranta et al. 2019) وتوصف مشاركة العامل بأنها عملية مصممة، لتمكين أعضاء المنظمة من اتخاذ القرارات، وحل المشكلات، وأن مشاركة العاملين تعتبر عاملا راسخا في إدارة الجودة الشاملة ومشاركة العاملين.
في حين بين العبداللات (2015) تتضح مشاركة العاملين من خلال اتخاذ القرارات، إذ تستجيب وتستمع الإدارة العليا إلى اقتراحاتهم وآرائهم، مما يؤدي إلى توليد إحساس، لدى العاملين بأهميتهم، فيبدون استعدادا كبيرا لتحمل المسؤولية، والعمل بكامل طاقتهم، لتحقيق أهداف المنظمة.
وقد أكد كل من Ganapavarapu & Prathigadapa,2015 أن العاملين على جميع مستوياتهم الوظيفية، هم جوهر المنظمة، ويجب وضع إستراتيجيات لضمان مشاركتهم الكاملة، حتى تتمكن المنظمة من الإفادة من قدراتهم، وكفاءاتهم. وفي سياق تفعيل دور المنظمة، في دعم مشاركة العاملين، وتعزيزهم، في تطبيق الجودة، يجب على المنظمة العمل على تطوير قدرات الأفراد على المستويات الفردية، والجماعية، والتنظيمية، وتعزيز العدالة والمساواة، وإشراك العاملين والاعتراف بإنجازاتهم وتشجيعهم للمساهمة في تحقيق الأهداف التنظيمية. (Mosadeghrad,2015)
ولابد للمنظمة من تحفيز العاملين على تحسين الجودة، من خلال إعطائهم فرصا للإبداع، وتقديم مقترحاتهم، وضمان العمل الجماعي، ومشاركة الجميع في الجودة (دودين، 2019)
ومما سبق، يُمكن القول إن تطور البنوك ، ونموها، يعتمد على مهارات العاملين وخبراتهم لديها، مما يتطلب الاهتمام بتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال مشاركتهم الفعّالة في القرارات المتعلقة بالجودة، والمساهمة في حل المشاكل التي تواجه الشركة، والاستماع إلى أفكارهم، التي من شأنها أن تساهم في تحسين وتطور أداء الشركة وتحقيق أهدافها.
- ثالثا: التحسين المستمر :
إن منظمات الأعمال تبقى دائما بحاجة إلى التحسين المستمر في أنشطتها، وعملياتها الداخلية، ومنتجاتها، فأذواق العملاء متغيرة، والبيئة التي تعمل من خلالها المنظمة بيئة متغيرة ومتجددة، فكل منظمة تعمل على تحسين العيوب، وتقليلها، في منتجاتها، حتى تستطيع أن تنافس غيرها من المنظمات، ومما جعل المنظمات تضع جل اهتمامها على التحسين المستمر وتعتبره فلسلفة إدارية، تهدف إلى العمل على تطوير العمليات، والأنشطة المتعلقة بطرق الإنتاج والتصنيع والآلات، والمواد والأفراد، وتعتبر إحدى ركائز إدارة الجودة الشاملة وتهدف إلى الوصول إلى الإتقان الكامل عن طريق التحسين، في عمليات الإنتاج (جودة،2018) ، قد يكون التحسين المستمر على مستوى الجودة والعاملين، والمنظمة (سويسي وأبو قفه، 2015). ومن أهم المداخل في مجال التصميم لمراحل عملية التحسين المستمر، هو اتباع منهجية حل المشكلات، وهي دورة (Plan Do Check Act (DCA للتحسين المستمر أو ما تسمى بدورة ديمنغ أو شيوارت، وقد تم تطويرها من قبل شيوارت ودمينج وتهدف هذه الدورة إلى تحسين الجودة، التي بدورها تؤدي إلى تحسين الأداء باستمرار، وتقليل الفرق بين متطلبات العملاء، وأداء المنظمة (جودة 2018)؛ “ومحور عمل هذه الدورة يكون من خلال تحديد “الخطةوالأهداف، والعمليات اللازمة لتحقيق النتائج ولتحسين الجودة، وفقا لمتطلبات العملاء. ( Keinan Karugu, 2018 )
أما المرحلة الثانية هي “التنفيذ تنفيذ العمليات والخطة الموضوعة في المرحلة الأولى، والمرحلة الثالثة هي الفحص والتي يتم من خلالها مراقبة وقياس النتائج وتقييمها ومقارنتها بالأهداف الموضوعة وفي حال وجود خطأ ما على الإدارة اتخاذ إجراءات تصحيحية وهي ما يسمى بالمرحلة الرابعة “الفعل”. -(Ganapavarapu&Prathigadapa,2015)
ومن وجهة نظر (جوران) أن التحسين المستمر يتألف من ثلاثة مكونات هي:
وكثير من الأدبيات أشارت إلى أن إدارة الجودة الشاملة عبارة عن برنامج للتحسين، والتطوير، التخطيط، ورقابة الجودة والتحسين ، لذا يتوجب على المنظمة أن تقوم بتقييم جودة المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء (علي (2016) وتتطلب إدارة الجودة الشاملة تغييرات في معتقدات المديرين والموظفين، ومواقفهم وسلوكهم، للتركيز على التحسين المستمر (Mosadeghrad, 2015)
ويهدف التحسين المستمر إلى السعي المتواصل والمستمر، لتطوير المنتجات والخدمات، والعمليات، وتحسينها، لتلبية حاجات العملاء، والحد من النشاطات التي لا تضيف قيمة إلى عملية إنتاج المنتجات والخدمات (الشعار والنجار، 2015).
وينعكس أثر التحسين المستمر على رفع أداء الموظف، الذي يشارك في تنفيذ إدارة الجودة الشاملة، فالتحسين المستمر يكون من خلال إدخال تحسينات مستمرة على كافة مجالات العمل في المنظمة، لمواكبة التغيرات والتكيف معها (المحاسنة (2016).
ولا يتم التحسين إلا من خلال تبني منهج إداري ، قادر على التكيف مع المتغيرات، والذي يتطلب إدارة الجودة الشاملة (المالكي 2018). ويشمل التحسين المستمر العديد من الأهداف التي تؤدي إلى إنشاء منتجات خدمات، أو تقديمها، خالية من العيوب، لتحقيق رضا العملاء وللتحسين المستمر عدد من المبادئ الأساسية، منها مشاركة المنظمة على جميع المستويات، وجمع البيانات، وتحديد البيانات التي تسهم في قياس التحسينات بشكل مستمر، وإنشاء فريق يضم ممثلين من جميع المجالات والأنشطة المختلفة في المنظمة، يعمل على تقديم حلول للإدارة، ويقوم بتنفيذ هذه الحلول، وعلى الإدارة دعم وضع آليات متابعة ومراقبة، تسعى إلى إدخال تحسينات إضافية مع مرور الوقت. (2018 Salah).
رابعا: التركيز على العملاء:
تركز المنظمات اهتمامها، وجهودها على خدمة العملاء الخارجيين، فيتوجب على المنظمة معرفة توقعات العملاء، ومتطلباتهم ومن ثم تقديم المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات عملائها، ورغباتهم، فينعكس ذلك على زيادة رضا العملاء، زيادة مبيعات المنظمة، وحصتها في السوق فقد أدرك متخصصو الجودة مثل (Deming و Juran و Crosby) أن التركيز على العملاء هو مفتاح للتحسين المستمر للجودة في المنظمة بشتى مجالاتها والكثير من المنظمات تطبق ما يسمى بمشاركة العملاء في تصميم المنتجات، بما يتوافق مع حاجاتهم، وأذواقهم (سويسي وأبو قفه، (2015)، لأن العميل هو أساس نجاح أي منظمة، أو فشلها، على اختلاف مجال عملها، وهو المشتري الحالي، أو المتوقع الذي يحتاج إلى المنتج، أو الخدمة، أو لديه الرغبة في شرائها، وفي الوقت نفسه لديه القدرة على الشراء، وقد يكون عميلا داخليا أو خارجيا (جودة 2018 2013, Foster) .
ويعتبر العميل الموجه للجودة، لذا يعتبر هذا نهجا استباقيا، لإشباع حاجات العملاء وتوقعاتهم، مما يتطلب جمع المعلومات عن حاجاتهم، وتوقعاتهم، وتفضيلاتهم ثم تقديم المنتجات والخدمات التي تشبع رغباتهم، وتحقق رضاهم. فالاهتمام برضا العملاء الداخليين، والخارجيين من أهم متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وأساسياته، فالعميل هو مركز اهتمام كافة الجهود لإدارة الجودة الشاملة، لذا لا بد من اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق رضا العملاء، وتقديم منتجات وخدمات، تلبي حاجاتهم، وتفوق توقعاتهم. (المالكي ، 2018).
كما أن التركيز على العملاء يكون من خلال الوعي الكامل بأن نجاح أي منظمة يعتمد بشكل كبير على العملاء، لذلك يجب أن تدرك المنظمات احتياجات العملاء، وتعمل على تلبية متطلباتهم، والسعي الجاد لتجاوز توقعاتهم. رضا العملاء يكون على ثلاث مستويات وتتمحور حول إذا كان أداء المنتج و / أو أقل من توقعات العميل فهنا العميل يكون غير راض، أما إذا تساوى أداء المنتج و / أو مع توقعات العميل هنا سيشعر العميل بالرضا وفي حال كان أداء المنتج و / أو الخدمة أكبر من توقعاته سيشعر العميل بالسعادة. (جودة 2018). وبالنسبة إلى منظمات الأعمال، فإن القوة الدافعة لتحديد أهداف الجودة تنبع أساسا من تحديد احتياجات العملاء، وتبدأ تلك الجودة بفهم احتياجات العملاء، ورغباتهم، ومعرفتها، وتنتهي عند تلبية تلك الاحتياجات. ومن أجل تلبية متطلبات العملاء يجب على الإدارة العليا معرفة توقعات العملاء، إضافة إلى ذلك، ينبغي أيضا تطوير الإستراتيجية التنظيمية بناء على احتياجات العملاء والتركيز على العملاء هو المبدأ الأساسي للمنظمات لتطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة العميل هو المحور الرئيس الإدارة الجودة الشاملة، فيتم الاستماع لصوت العميل بواسطة المقابلات الشخصية، أو الاستبانات، أو إشراكهم ضمن فرق الجودة، أو نظام الاقتراحات (الشعار والنجار، 2015).
وتلجأ المنظمات إلى تطبيق بيت الجودة، لتحديد حاجات عملائها، ورغباتهم، وهي وسيلة لترجمة متطلبات العميل إلى مواصفات تدخل في تصميم المنتج، وهو منهج علمي يركز على الارتقاء بجودة تصميم المنتج وتطويره، من خلال الإصغاء لصوت العميل والمصمم، والمنافسين، لتقديم منتج يحقق ميزة تنافسية للمنظمة. (Foster, 2013) وتعتمد المنظمات على عملائها، لذلك يجب عليهم معرفة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعملاء، وتحقيق احتياجاتهم، وتجاوز توقعاتهم، من خلال البحث لفهم جميع احتياجات العميل وتوقعاته، ومعرفتها، من حيث المنتجات والخدمات وتاريخ التسليم، والسعر والموثوقية، وربط الأهداف الموضوعة باحتياجات وتوقعات العميل، ومتابعة تحقيق التوازن بين احتياجات العملاء وتوقعاتهم، وأصحاب المصلحة الآخرين. (2017,Al-Damen).
ومما سبق ترى هذه الدراسة، أن البنوك تدرك أهمية العملاء، وتعتبرهم أساس عملها، وسر بقائها، ووجودها، وتعتبر العميل الهدف الرئيسي الذي تسعى إلى تحقيق رضاه لذلك تركز على معرفة حاجات ورغبات عملائها، والعمل على إشباعها، وتحقيق رضاهم.
المبحث الثاني : جودة حياة العمل
تمهيد
تعد جودة حياة العمل من القضايا الإدارية التي احتلت مكانا متميزا في أدبيات إدارة الموارد البشرية، والسلوك التنظيمي نظرا لأنها مفهوم يحتوي على العديد من العناصر التي تمس إدارة المنظمة مباشرة وتؤثر عليها، وهذا المفهوم رغم أنه قد يبدو قاصرا على البيئة المباشرة للعمل إلا أنه يلمس أيضا الحياة الشخصية للأفراد باعتبار أن الفرد هو كائن بشري له العديد من المشاعر والاهتمامات الشخصية، والتي ما لم يتم مراعاتها، فإنها بالقطع سوف تلقي بظلالها السيئة على أداء الموظفين وروحهم المعنوية والتزامهم التنظيمي، ومن ثم على كفاءة وفعالية وأداء المنظمات التي يعملون فيها.
وتعتبر جودة حياة العمل مع المفاهيم الإدارية الحديثة الواسعة النطاق، فهي تنطلق من توفير بيئة عمل آمنة وصحية وهادئة إلى المشاركة والإدارة الذاتية في العمل التنظيمي وينظر إليها على أنها احد الركائز الأساسية التي يستند عليها برامج الجودة لدى الكثير من المنظمات في الدول المتقدمة من أجل تطوير وانتقاء أفضل المناهج وتنمية ثقافة جودة الاستغراق الوظيفي لدى مواردها البشرية.
فهي من المفاهيم المتعددة الأبعاد، والتي شملت تحسين بيئة العمل، وتوفير ظروف العمل المعنوية، وعدالة نظام الأجور والمكافات، والمشاركة في اتخاذ القرارات، فضلا عن جماعات العمل وفرق العمل، والذي بدوره يؤدي إلى تحسين الوضع التنافسي للمنظمة.
وفي هذا المبحث فإن الباحث يقدم إطارا نظريا حسب الأدبيات المرجعية لجودة الحياة الوظيفية، وتسليط الضوء على المفهوم، والأهمية، والأهداف، والأبعاد الرئيسـة لها، وعناصرها المختلفة في المنظمات، ومعوقات تطبيق جودة حياة العمل في المنظمات، وذلك على النحو التالي:
2-2-1مفهوم جودة الحياة الوظيفية.
لقد تعددت وتنوعت تعاريف جودة حياة العمل حسب وجهة نظر العلماء والباحثين في هذا المجال من بينها عرفها “جاد الرب” جودة حياة العمل بأنها: “مجموعة من العمليات الكاملة المخططة والمستمرة والتي تستهدف تحسن مختلف الجوانب التي تؤثر على حياة الوظيفية للعاملين وحياتهم الشخص أيضا، والذي يهم بدوره في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمنظمة والعاملين فيها والمتعاملين معها”.(عمران، 2020)
وعرفها إسماعيل على أنها: “الأوضاع وبيئة العمل المميزة والمفضلة للعاملين التي تدعم وتعزز رضا الموظفين من خلال العلاوات والأمن الوظيفي وفرص النمو في المنظمة” (اسماعيل، 2016).
وعرفها “ماضي” جودة حياة العمل على أنها مجموعة من الأنظمة والبرامج المرتبطة لتحسين وتطوير مختلف الجوانب الخاصة برأس المال البشري للمنظمة، والتي من شانها أن تؤثر على حياة الوظيفة للأفراد وبيئتهم الاجتماعية والثقافية والصحية، والذي بدوره ينعس إيجابا على مستوى الأداء الوظيفي للعاملين، ومن ثم يساهم في تحقيق أهداف المنظمة والفرد وكافة الأطراف ذات علاقة بالمنظمة. (الالمعي، 2020)
كما تعني جودة حياة العمل “ظروف عمل جيدة وإشراف جيد، ومكافآت جيدة، وقدر من الاهتمام والتحدي بالوظيفة، وتحقق جودة حياة العمل من خلال فلسفة علاقات العاملين التي تشجع استخدام جهود جودة
الحياة الوظيفية لإعطاء العاملين فرص أكبر للتأثير على وظائفهم والمساهمة الفعالة على مستوي المنظمة ككل. (المغربي، 2004).
كما تم تعريف جودة حياة العمل بأنها هدف وعملية وفلسفة في آن واحد، حيث الهدف التزام أي منظمة بتحسين العمل، أما العملية فتتضمن الجهود المبذولة لتحقيق هذا من خلال إشـراك الجميع في المنظمة من خلال التركيز بشدة على التنمية الفردية والتنظيمية والطرق المعمول بها، وأخيرا فلسـفة فهي تعلى الكرامة الإنسانية لجميع أفراد المنظمة.(أبو العينين ،2019)
كما تعرف جودة حياة العمل بأنها توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين بالمنظمة لمساعدتهم على بناء علاقات طبية والنهوض بصحتهم ورفاهيتهم ورضـاهم الوظيفي وتنمية كفاءاتهم والتوازن بين العمل والحياة خارج نطاق أعمالهم مما يؤثر على الأداء الوظيفي الكلي. (الضاوية وخليل ،2021)
وتم أيضـا تعريفها بأنها “المدى الذي يكون فيه الموظف راضيا عن إشباع حاجاته الشـخصـية وحاجات العمل من خلال المشاركة في الأمور المتعلقة بالعمل، وتحقيق أهداف المنظمة”. (Almalki .etal,2011)
وعرف (الزيادى ،2015) جودة حياة العمل بأنها توافر العناصـر الأسـاسـية المؤثرة في بناء التصـورات الإيجابية لدى الموظفين نحو متغيرات البيئة التنظيمية وتقاس من خلال الرضـا الوظيفي، والضمان الوظيفي والالتزام التنظيمي والاستقلالية، ومشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات والقدرة على تحقيق الأداء.
ويرى الباحث أن جودة حياة العمل تتمثل في توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين داخل المؤسسات، والمساهمة في إشباع حاجاتهم الأساسية للحصول على مستويات أفضل للأداء، والذي بدوره ينعكس إيجابيا على فاعليه اتخاذ القرارات الإدارية، ومن ثم تحقيق الأهداف التي تسعى اليها المنظمة.
2-2-2- اتجاهات دراسة جودة الحياة الوظيفية:
يرتكز مفهوم جودة حياة العمل على أساس مدرستين كل منها تحاول التركيز على جوانب معينة أثناء تناولها لهذا الموضوع، الأولى تكرسها على أساس مقاربة مدرسة الموارد البشرية التي تؤكد على إرضاء حاجات الأفراد، أما الثانية فتقوم على أساس المقاربة التقنية ، وسنحاول التطرق إلى كل منها على حدا، وإن كان تعريف جودة الحياة في العمل يختلف من دولة إلى أخرى حسب موروثها الثقافي والتاريخي.
أولا: اتجاه مدرسة الموارد البشرية:
يركز هذا الاتجاه على ضرورة إشباع الحاجات الداخلية والخارجية للفرد ويؤكد على دور الفرد في المنظمة (المشاركة في اتخاذ القرار، الاستقلالية …الخ) على نحو يجعل الشخص أكثر ارتياحا، وأن فلسفة الإدارة تؤكد على الرغبة في الانتماء إلى الجماعة والانضمام إليها عن طريق تبادل المعلومات بين مختلف المستويات وحرية التعبير لدى العمال والتعرف على الصراعات وحلها بشكل سريع وبذل المجهود لذلك والتأكيد على ذلك، أما المعلومات الغير رسمية والتي
تمثل الجانب الاجتماعي والنفسي من أجل زيادة الفهم للشعور بالانتماء لدى الأفراد، حيث يعتبر الوسط المهني فضاء للاندماج وتنشئة الفرد، حيث يسمح للفرد بالانتماء إلى مجتمع المؤسسة وتحقيق علاقات اجتماعية.
كما أن الأهمية تتعلق بإشباع الحاجات وتقدير الذات وتنشيط الفرد بإشراكه بشكل واسع في اتخاذ القرار مما يضفي مجموعة من المسؤوليات الفردية والجماعية داخل المنظمة، وفي إدارة المنصـب الموكل إليه، وهذا ما يمنح تصرفا واسعا في منصب العمل من خلال الاقتراحات والأحكام الفردية التي تقضي إلى إثراء المهنة والتطور المعرفي. (الضاوية وخليل ،2021)
ثانيا: المقاربة التقنية – الاجتماعية:
حيث بين بعض الباحثين أن مفهوم جودة الحياة في العمل يجب أن يراعي العمال ومحيطهم العام مع إعطاء أهمية للمنظمات العمل، وكذلك أيضا الجانب الإنساني إن كان مهملا والذي يسمى بالنسق التقني الاجتماعي، أما البعض الآخر فيرون إن هذا المفهوم يجب أن يراعي إعادة بناء نماذج وطرق العمل، التكيف التكنولوجي، تعديل النسق التنظيمي وحسب رأيهم فإن جودة الحياة في العمل يجب أن تراعي المشاركة الواسعة للعمال في الوسط المهني مما يتيح لهم مسؤوليات كبرى مما يتيح سيرورة التعلم الديناميكي للتحقيق التطور، وهذا المفهوم يأخذ في الحسبان العوامل الاجتماعية والتكنولوجية التي لا تتحقق إلا بإشراك العنصر البشري فيها.
وعلى حسب هذا النموذج فإن فعالية الأداء تتحقق باتحاد الجانب الاجتماعي والتقني لكل منظمة، فالجانب الاجتماعي والذي يتمثل في العامل البشـري والأدوار والعلاقات ونظام الاتصالات والسلطة والمسؤوليات وأنظمة التقويم والتقييم، وميكانزمات التكيف والاندماج للفرد داخل التنظيم، الخدمات داخل المؤسسة (التوظيف والانتقاء، التكوين). أما الجانب التقني لاسيما يكون في الإجراءات، التجهيزات، البرامج ، الحواسيب ….الخ. وأن جودة الحياة في العمل تتعزز عن طريق التفاعل بين هاذين الجانبين. (Ilyas,2013)
وتستند كذلك معاير جودة الحياة في العمل إلى إعادة تنظيم العمل والمنظمة لهدف تحسين عملية التعايش داخل المنظمة، حيث أن الفعالية تقتضي استعمال وتجريب عدة جوانب خاصة بالمنظمة لأهداف متعددة الأبعاد التي تؤدي إلى العدالة والديمقراطية في الوسط المهني، والتشجيع على التشاور وإدارة المشاكل في العمل وجعل العمال يتحكمون في بيئتهم المهنية.
إن جودة حياة العمل يجب دراستها من وجهة نظر العاملين متمثلة في جودة البيئة المادية للعمل، وجودة المدخلات، والعمليات والمخرجات، والبيئة المحيطة بمكان العمل بما تتضمنه من عناصـر اجتماعية ومادية ونفسية للوظيفة أي التركيز على منظومة العمل ككل وكذلك الرضا الوظيفي وأعباء الوظيفة، ويمكن توضيحها من خلال الشكل التالي: (1)
source: Ilyas, Seema Arif Maryam, (2013), “Quality 0 of Work-Life Model for Teachers of Private Universities in Pakistan”, Quality Assurance in Education, Vol. 21, No.3, P. 282–298
2-2-3 أهداف جودة الحياة الوظيفية.
يتناول مفهوم جودة حياة العمل الجهود والأنشطة المنظمة التي تستخدمها إدارة الموارد البشرية في المنظمة بغرض توفير حياة وظيفية أفضل للموظفين إشباع احتياجاتهم من خلال توفير بيئة عمل صالحة، ومشاركتهم في اتخاذ القرارات وتوفير متطلبات الأمن والاستقرار الوظيفي والعاطفي لهم، وإتاحة الفرص الملائمة لتحسين الأداء، وتعتبر كذلك على أنها مجموعة من العمليات المتكاملة المخططة والمستمرة والتي تستهدف تحسين الجوانب التي تؤثر على الحياة الوظيفية للموظفين وحياتهم الشخصية أيضاً، والذي يسـاهم بدوره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة والعاملين فيها والمتعاملين معها.
وقد ظهر مفهوم جودة حياة العمل ليواكب سـياسـات التغيير والتطوير التنظيمي، وليخفف من حالات التوتر والقل التي سادت في الغرب بين العاملين خوفاً من الاستغناء عنهم، أو تخفيضـاً للخدمات والمزايا الاجتماعية المقدمة لهم، أو تخفيضات لمعدلات أجورهم، بجانب حرص تلك المنظمات على تحقيق الرضا الوظيفي المؤثر على التزام العاملين، ومن ثم تعظيم أهمية استخدام وترشيد أداء الموارد البشرية، واعتبارها أحد الاستراتيجيات الفعالة في تدعيم التميز التنافسي لمنظمات الأعمال. (Mazloumi.etal,2014)
وعليه فإن جودة حياة العمل تحقق أهدافا لكل من الموظف، والمنظمة كما يلي:
أولا: أهداف جودة حياة العمل للموظف.
شعور الموظف بالثقة في المنظمة نظرا لما توفره من ظروف عمل آمنة ومستقرة والمحافظة على كرامة الموظف وتوفير فرص التنمية والنمو الوظيفي كما أنها تساعد على إضفاء الطابع الإنساني بمجال العمل وتوفر الوظائف المناسبة بالإضافة إلى توفير الأمان الوظيفي وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للأجور والمزايا وتوفر للعامل حرية التعبير الذاتي عن آرائه مما يساعد على زيادة إنتاجية الموظف التي تدعم الفاعلية التنظيمية. (الألمعى ،2020)
كما تغطي جودة حياة العمل مشـاعر الفرد عن العمل، بما في ذلك المكافآت الاقتصادية والأمن الوظيفي والعلاقات التنظيمية والعلاقات الشخصية النابعة من تحسين بيئة وظروف العمل.
كما أن أهداف الموظفين من تطبيق جودة حياة العمل في ما يلي (عمران ،2020):
- تقلد وظائف تتناسب مع المؤهلات العلمية والعملية وتنمية ومواكبة الخبرات والقدرات للموظفين.
- الاستفادة من فرص الترقية والتدرج الوظيفي بما يحقق الذات.
- الحصول على مستوى مناسب من الأجور والعلاوات.
- إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية والأمنية والاجتماعية، وحاجات المكانة والتقدير وتحقيق الذات .
ثانيا :أهداف جودة حياة العمل للمنظمة.
تؤدي إلى إيجاد قوة عمل أكثر مرونة وولاء ودافعية ويعتبر ذلك ضروريا لتعزيز القدرات التنافسية للمنظمة في دنيا الأعمال من ناحية الجودة في تأدية الخدمات ووصولها للعملاء والمرونة والريادة التكنولوجية بالمقارنة بالمنافسين كما يتراجع معدل الغياب عن العمل ومعدل دوران العمل وزيادة الرضا الوظيفي مما ينعكس على أداء المنظمة إلى الأفضل وزيادة القيمة المضافة التي تحققها
كما أن جودة حياة العمل تهدف إلى كيفية تصميم العمل بكل جوانبه من حيث التنظيم، والسلطة، والجماعات، وتدفق إجراءات العمل، وساعات العمل، وخصائص العمل ذاته، وذلك بحيث تضمن أن الحياة التي يحياها الموظفون داخل أعمالهم يجب أن تكون ذات جودة عالية. (إسماعيل ،2016)
وتتطلب جودة حياة العمل من المديرين الاهتمام بمعاملة المرؤوسين والعناية بهم بكل احترام وتبجيل حيث ينصب تركيزها على الموظفين وإدارة عمليات الإعمال معا، كما أنه لزيادة الكفاءة التنظيمية والفاعلية داخل المنظمة لابد من أن تكون أهداف جودة حياة العمل الأهداف الرئيسة للمنظمة بشكل عام، مما يسهم في تعزيز قدرة المنظمة وتحقيق نابعة من مستويات أفضل للأداء، ومن أبرز الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها إدارة الموارد البشرية من خلال برامج تطوير جودة حياة بيئة العمل هو جعل بيئة العمل مصدر جذب للموظفين الجيدين، والمساعدة على زيادة انتماء العاملين إلى المنظمة ، والمساهمة في تعزيز الجودة، والتعلم، والإبداع، وزيادة ثقة العاملين، والمشاركة في حل المشكلات، والإسهام في توفير قوة عمل اكثر مرونة، وولاء ودافعية .(الدمرداش،2018)
2-2-4 أهمية جودة الحياة الوظيفية
تسعى المنظمات إلى تحقيق مزايا متعددة نتيجة تبليها البرامج جودة حياة العمل حيث أنها لا تسهم في تنمية قدرة المنظمة على توظيف أشخاص أكفاء فقط، ولكنها تعظم أيضا قدرة المنظمة التنافسية وتسهم بشكل إيجابي في توفير قوة عمل أكثر مرونة، وولاء ودافعية وتوفير ظروف عمل محسنة ومطورة من وجهة نظر العاملين، كما تساعد في تعظيم الفعالية التنظيمية من وجهة نظر أصحاب المنظمة مع التأثير الإيجابي على ممارسات إدارة الموارد البشـرية مثل التدريب وانتقاء فريق العمل واستقطاب العاملين، والتأثير الإيجابي على الأداء التسويقي للشركة. (موسى،2015)
هذا وقد بدأت كثير من المنظمات في تبني برامج جودة حياة العمل بما يحقق لها عديد من المزايا، ومنها تعظيم القدرة التنافسية، وتوفير قوة عمل أكثر مرونة وولاء، وأيضا توفير ظروف عمل أفضل، وأن نجاح برامج جودة حياة العمل يتضمن منح الموظفين الفرصة للمساهمة في وضع الأهداف، واتخاذ القرارات، وتشجيعهم على المشاركة في حل المشكلات، وكذلك الإحساس بالأمان الوظيفي والذي ينعكس عليهم بصوره إيجابيه في ممارساتهم الإدارية سواء داخل بيئة العمل، أو خارجها .
وترجع أهمية برامج جودة حياة العمل بأنها تمثل البذرة الأساسية لنجاح الكثير من المنظمات، وذلك لما يعود عليها من زيادة بالإنتاجية، وفي الوقت نفسـه تحقيق طموحات الموظفين من خلال إشباع حاجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، وتعد جودة حياة العمل من المفاهيم الإدارية الهامة في إدارة الموارد البشرية؛ لما لهذا المفهوم من تأثير مباشر في رفع الروح المعنوية للعنصر البشري والتغيير في سلوكه السلبي نحو الإيجابية، وبالتالي تحسين أداء المنظمة، والقدرة على اتخاذ القرارات الفعالة. (القرشى والقحطانى ،2018)
وأن هذه البرامج تعمل على إحداث التوازن والانسجام بين الحياة الوظيفية للأفراد وبين حياتهم الشخصية والعائلية، مما يؤدي إلى زيادة الولاء التنظيمي، وتخفيض تكاليف التأمين الصحي، وانخفاض معدلات التعويض المدفوعة نتيجة حوادث العمل، وزيادة المرونة والتكيف من ناحية قرة العمل لتزايد الإحساس بالمشاركة والملكية، واختيار عمالة أفضل، وقد تبين أن هناك تأثيرات إيجابية بناءة لتوافر ، وتطبيق أبعاد جودة حياة العمل ومن أهمها ما يأتي: (الدمرداش ،2018)
- تقليل صـراعات العمل بين العاملين والإدارة وذلك بخلق بيئة عمل أكثر انتاجية، وحل جميع المظالم و تهيئة مناخ جيد للعمل يساعد في حل المشكلات.
- مشاركة واسعة من القوة المؤثرة في أعضاء العمل بالعديد من الأفكار الجيدة والبناءة التي تساعد في عملية تحسين الأبعاد الخاصة بعمليات التصنيع وظروف العمل.
- زيادة الطمأنينة والولاء والانتماء لدى العاملين والموازنة بين أهدافهم الشـخصـية وأهداف المؤسسة بشكل عام.
- تحسين العلاقات الإنسانية في المؤسسة ودعمها.
- انخفاض معدل غياب العاملين في المؤسسة.
- زيادة الفعالية والكفاءة التنظيمية داخل المؤسسة.
- استثمار أفضل وأمثل للموارد البشرية في المؤسسة.
كما تبين أن جودة حياة العمل تكتسب أهميتها كونها استراتيجية متكاملة يمكن أن تقود المنظمة الى النتائج الآتية: (عباس وعنيد،2021)
- التفوق الواضح للموظفين في الجوانب الإدارية حال تعرض المؤسسة لمشاكل، قد تعرقل نشاطها، وتعطل برامجها.
- الاحتفاظ بكوادر من الموارد البشرية من ذوي الكفاءة والمهارة والمعرفة، كما أنها فرصة للنمو والتطور حيث إن استقرار الموارد البشرية يمكن أن يسهم في تحقيق ذلك.
- تزيد من اهتمام الإدارة بأفكار العاملين، وتزيد من اهتمام الموظف بأفكاره التي تكرسها الإدارة.
- الالتزام: تخلق التزام من قبل الموظف تجاه المنظمة (جودة السلع والخدمات).
- الاتصالات: تزيد من حرص الموظفين على الاتصال بالمشرفين.
- المنافسة: تسمح للمنظمة أن تكون أكثر منافسة من خلال تحسين التكاليف والجودة والالتزام نحو جودة الحياة الوظيفية.
- التطوير: تطور المشرفين لتحولهم إلى قادة أفضـل وصـناع قرار بتزويدهم بأدوات حديثة.
- الابتكار: تشجع على الابتكار من خلال احترام أفكار الموظفين.
- الاحترام: تظهر احترام الإدارة للموظفين واحترام الموظفين للمشرف.
- الرضا : تزيد من رضا الموظفين من خلال المشاركة في صنع القرار، كما تعزز رضا المشرفين عن طريق تحسين الاتصالات، وأيضا تقلل من عدم رضا العامل على الإشراف الناتج عن مقاومة التغيير.
إن من أسباب الاهتمام بجودة حياة العمل أهميتها في التعامل مع المنافسة الأجنبية والشكاوي ومشكلات الجودة ومعدلات الإنتاجية المتدنية في بعض المنظمات وتقريبا كل شيء آخر واعتبروها موضوع أخلاقي يجب الاهتمام به في المنظمات.
2-2-5 معوقات تطبيق جودة حياة العمل
إن المعوقات التي تقف حائلا أمام تطبيق برامج جودة حياة العمل في المنظمات كثيرة ومتنوعة، خاصـة بان الإدارة، والموظفين، والنقابات المهنية، والعمالية لهم وجهات نظر مختلفة حول جدوى هذا التطبيق، وأهم هذه المعوقات هي: (القرشى والقحطانى ،2018)
- تخوف الإدارة العليا بمستوياتها المختلفة من مشاركة مستويات تنظيمية دنيا في صناعة القرارات، ومعارضتهم لهذا الأمر.
- تقدير الإدارة العليا المستويات الإدارية بأن برامج المشاركة للموظفين ضمن برامج ومعايير جودة حياة العمل قد لا تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمستدامة للمؤسسة، بل تهتم وتعمل على تحقيق الأهداف ذات المدى القصير جدا، ونتيجة لذلك فإن المستويات الدنيا تصاب بالإحباط مما يؤدي لآثار سلبية على المؤسسة.
- فشل بعض الإدارات بقياس أثر تطبيق جودة حياة العمل على نفسيات ورضا العاملين عن العمل، وإهمالها للمقترحات التي يتقدم بها الموظفون، وعدم أخذها لهذه المقترحات على محمل الجد لتقوم بدراستها بجدية.
- اعتقاد بعض الإدارات بأنه لا حاجة لإجراء المزيد من التحسين في هذه المؤسسات من خلال تطبيق المزيد من عناصر جودة حياة العمل فيها.
- عدم الإدراك الصـحيح من جانب الموظفين لأهداف وأهمية برامج جودة حياة العمل والقيمة المتبادلة التي يمكن أن تحققها هذه البرامج لكل من الإدارة والموظفين.
عدم قيام المؤسسات بتقدير الاحتياجات التدريبية للمستويات الإدارية المختلفة لديها، وما يحتاجونه من تعليم وتدريب؛ ليكونوا قادرين على التفاعل مع هذه البرامج بما يحقق الأهداف للمؤسسات والموظفين على حد سواء.
المراجع
- إبراهيم، أمل أبو زيد وفضل الله، إشراقة عوض (2019) أثر تطبيق معايير الجودة الشاملة على الميزة التنافسية في المنشآت الخاصة : دراسة حالة مجموعة شركات دال للمواد الغذائية. مجلة رماح للبحوث والدراسات 35 205-222
- اسماعيل، إبراهيم ماضي خليل،(2016) ، الممارسات الإستراتيجية والمهارات الفكرية للقيادة الجامعية ودورها في تحسين جودة الحياة الوظيفية للعاملين في الجامعة الإسلامية، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات الإدارية والاقتصادية، مجلد الثاني، عدد5.
- اللالمعي على بن عبد الهادي، (2020)، الرضا الوظيفي كمتغير وسيط في العلاقة بين التدوير الوظيفي والأداء الوظيفي في فنادق الخمس نجوم بالمملكة العربية السعودية، مجلة كلية السياحة والفنادق، مجلد 4، العدد4.
- جودة، محفوظ أحمد . (2018) إدارة الجودة الشاملة – مفاهيم تطبيقات دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة. عمان، الأردن.
- دودين، أحمد يوسف (2019) إدارة التغيير والتطوير التنظيمي. دار اليازوري.aspx العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
- الدمرداش، أحمد محمد، (2018)، جودة الحياة الوظيفية والأداء الوظيفي، (القاهرة: مكتبة دار الحكمة، مصر).
- الرميدي، بسام وأبو زيد رضا (2020) أثر جودة الحياة الوظيفية على الأداء والفاعلية التنظيمية في شركات السياحة المصرية الإستغراق الوظيفي كمتغير وسيط. مجلة كلية السياحة والفنادق، 1(4) 25-20
- سويسي، عز الدين علي محمد وأبوقفة، هدية منصور خليفة (2015). أثر إدارة الجودة الشاملة في تعزيز الميزة التنافسية في شركة المزرعة للصناعات الغذائية. مجلة الاقتصاد والتجارة، 7، 190-212 سيف صوالحه، جريدة الرأي. 2020/8/5 صفحة 24-25
- الشعار، قاسم ابراهيم والنجار، فايز جمعه (2015) تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وأثرها في الإبداع التكنولوجي (دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في الاردن) دراسات العلوم الإدارية. 42 (2) 409-425.
- الضاوية ،حرمة و خليل ،منال ،(2021)، جودة حياة العمل وأثرها على تحسين أداء الموارد البشرية دراسة ميدانية للمؤسسة السونلغاز،رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أحمد دراية بأدرار ،الجزائر.
- العبد اللات، خليل عقله محمد (2015) قياس أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على الميزة التنافسية في المستشفيات الخاصة الأردنية مجلة البحوث المالية والتجارية، 2، 228-250
- عباس، بشرى وعنيد، حسين (2021). تأثر ادارة الجودة الشاملة على جودة حياة العمل دراسة تحليلية لآلراء عينة من العاملين في شركة نفط ميسان. مجلة الدراسات المستدامة ، (3)3، 474-465 .
- علي، حسام قرني أحمد . (2016)، أثر تطبيق الجودة الشاملة على الأداء الإداري للمنظمات، الفكر الشرطي varsigma (86) * 6 in I-00 pi*
- عباس، بشری عبد الحمزة وعنيد، حسین بريو.( 2021). تأثير إدارة الجودة الشاملة على جودة حياة العمل: دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في شركة نفط ميسان، مجلة الدراسات المستدامة، مج (3)، 446-474.
- عمران،على حسن عبد السلام، (2021)، دور جودة الحياة الوظيفية في تحسين الأداء الوظيفي –دراسة تحليلية لأداء عينة من العاملين بالمصاريف التجارية بمدينة مرزق، مجمة المنارة للدارسات القانونية والإدارية
- المالكي، أحمد محمد (2018) متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات العامة مجلة التنمية البشرية والتعليم للأبحاث التخصصية، 1(4) 210-234
- المحاسنة، محمد عبد الرحيم . (2016) أثر إيداع سلسلة التوريد في إدارة الجودة الشاملة من خلال جودة المعلومات كمتغير وسيط دراسة ميدانية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. مؤتة للبحوث والدراسات ، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية 156-113 )2( 31
- منصور، كويحل وعماد، طبعان (2019). علاقة بيئة العمل بتحسين أداء العمال دراسة ميدانية بالمؤسسة المينائية رسالة ماجستير، جامعة محمد الصديق بن يحي، الجزائر .
- الموايضة، يوسف والجعافرة، عامر (2021) أثر جودة حياة العمل على الأداء المؤسسي دراسة تطبيقية على المستشفيات الخاصة العاملة في محافظة الزرقاء. مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث، 3(7)، 203-195.
- عقيلي، عمر وصفي (2009) مدخل إلى المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة، الطبعة الثانية. دار وائل للنشر، عمان، الأردن.
- Ackah, D. (2019). The Consequence of Total Quality Management and Performance Appraisal on Employee Occupation Satisfaction in Nominated Establishments. Journal of Researchers, 4(2), 1-29.
- Al-Shawabkeh, Z. (2019). The Impact of Total Quality Management Practices on Strategic Agility in Jordanian Concrete Companies. Master Thesis, Middle East University, Jordan.
- Al-Damen, R. A. (2017). The impact of Total Quality Management on Organizational Performance Case of Jordan Oil Petroleum Company. International Journal of Business and Social Science, 8(1). 192-202.
- Aletaiby, A., Kulatunga, U., & Pathirage, C. (2017). Key Success Factors of Total Quality Management and Employees Performance in Iraqi Oil Industry. In 13th IPGRC 2017 Full Conference Proceedings, University of Salford, 668-679.
- Al-Qudah, K. A. (2021). The Impact of Total Quality Management on Competitive Advantage of Pharmaceutical Manufacturing Companies in Jordan. Perspectives of Innovations, Economics and Business, PIEB. 12(3), 59-75.
- Al-Sarayreh, A., Al-Shatnawi A., Al-Madhoun R., Al-Faqeeh N., A., Al-Tarawneh, S., Al-Hlool, M.; Smadi,Q., Al-Samoor, M., Al-Akra Y., Sliehat, O., Hussain M. & Qowar,M.(2019). The Impact of TQM on Employee Performance Abu Sheikha Exchange Company: Case Study, International Journal of Human Resource Studies, 9(2),212-224.
- B.C. (2017). The Advantages Of Implementation of Total Quality Management in Enterprises. Annals of The Constantin Brancusi” University Of Targu Jiu, Engineering Series, 1,56-59.
- Androniceanu, A. (2017). The Three-Dimensional Approach of Total Quality Management, An Essential Strategic Option For Business Excellence. Amfiteatru Economic, 19(44), 61-78.
- Boikanyo, D. H., & Heyns, M. M. (2019). The Effect of Work Engagement on Total Quality Management Practices in a Petrochemical Organisation. South African Journal of Economic and Management Sciences, 22(1), 1-13.
- Bouranta, N., Psomas, E., Suárez-Barraza, M. F., & Jaca, C. (2019). The key factors of total quality management in the service sector: A cross-cultural study. Benchmarking: An International Journal.
- Dale, B. G., Bamford, D., & van der Wiele, T. (Eds.). (2016). Managing quality: An essential guide and resource gateway. John Wiley & Sons
- El Hawi.R., & Alzyadat, W. (2019). TQM Measured Students’ Satisfaction in the Jordanians’ Private University for Achieving Institutional Excellence. TEM Journal. 8(2), 409-416.
- El-Tohamy, A. & Al Raoush, A. T. (2015). The Impact of Applying Total Quality Management Principles on The Overall Hospital Effectiveness: An Empirical Study On The HCAC Accredited Governmental Hospitals in Jordan. European Scientific Journal, 11(10), 63 – 76
- Foster,S.T. (2013). Managing Quality -Integrating the Supply Chain, Fifth Edition, Pearson.
- Ganapavarapu, L. K., & Prathigadapa, S. (2015). Study On Total Quality Management For Competitive Advantage In International Business. Arabian Journal of Business and Management Review, 5(3), 1-4.
- Jonah, N., Ornguga.I.G & Torsen, E. (2018). The Effect of Total Quality Management (TQM) on the Organizational Growth of Adama Beverages: A Marketing Mix Perspective. International Journal of Science and Research, 7(7), 1096-1102.
- Keinan, A. S., & Karugu, J. (2018). Total Quality Management Practices and Performance of Manufacturing Firms In Kenya: Case Of Bamburi Cement Limited. International Academic Journal of Human Resource and Business Administration, 3(1), 81-99.
- Kim, G. S. (2016). Effect of Total Quality Management On Customer Satisfaction. International Journal of Engineering Sciences & Research Technology, 5(6), 507-514.
- Mohamed, M. B., Ndinya, A., & Ogada, M. (2019). Influence of Cost Leadership Strategy On Performance Of Medium Scale Miners in Taita Taveta County, Kenya. International Journal of Development and Management Review, 14(1), 151-163.
- Mosadeghrad, A.M. (2015). Developing and validating a total quality management model for healthcare organizations. The TQM Journal, 27(5), 544-564.
- N.A, Yousif.A.S.H & Al-Ensour, J. A. (2017). Total quality Management (TQM), Organizational Characteristics and Competitive Advantage. Journal of Economic & Financial Studies, 5(4), 12-23.
- Singh, V., Kumar, A., & Singh T. (2018). Impact of TQM on Organisational Performance: The case of Indian Manufacturing and Service Industry Operations Research Perspectives, 5.199-217.
- Salah ,S.A.(2018) . Total Quality Management Practices and Performance of Commercial Banks in Garissa County, Kenya. International Academic Journal of Human Resource and Business Administration, 3(1), 52 – 67
- Oakland, S. (2014). Total Quality Management and Operational Excellence: Text with cases, fourth edition.
- Ooi, K. B., Lee, V. H., Chong, A. Y. L., & Lin, B. (2013). Does TQM improve employees’ quality of work life? Empirical evidence from Malaysia’s manufacturing firms. Production Planning & Control, 24(1),,72- 89.
- Srinivasaiah, R., Renuka, S & Nanjundeswaraswamy, T. (2021). Quality
- management practices and quality of work life a conceptual model development. International Journal of Quality & Reliability Management, 1(1), https://doi.org/10.1108/IJQRM-06-2021-0189.